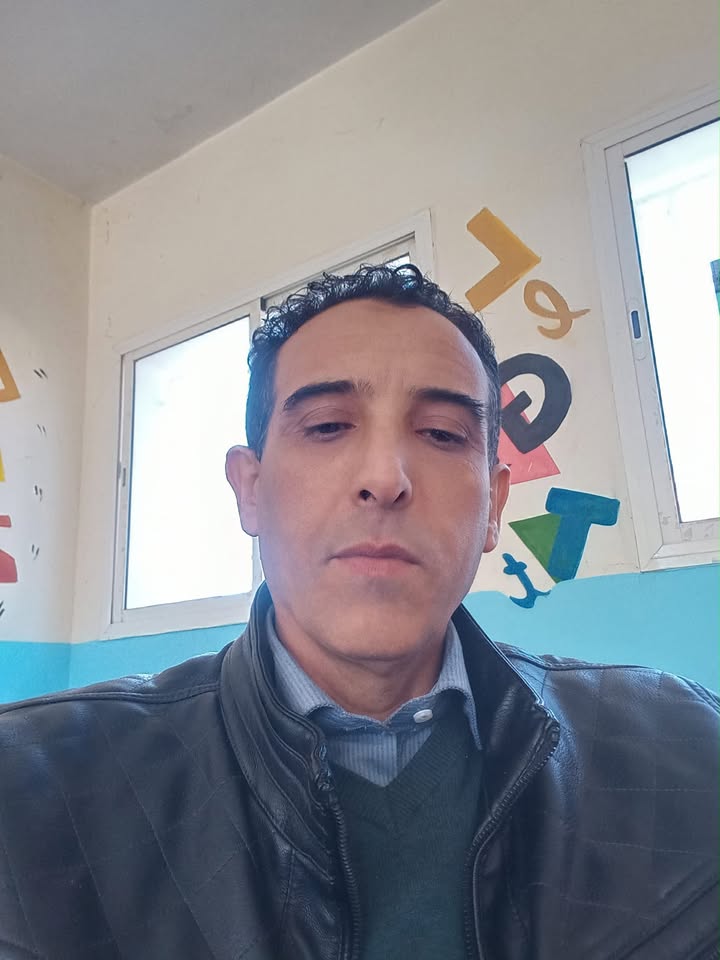لا شك أن كلما أُثير موضوع التحديث والتأسيس لدولة مدنية في المجتمعات العربية إلا وتم ربط الأمر مباشرة زمانيا ببداية القرن الثامن عشر ، حيث تلفي الكثير من الباحثين والمثقفين يؤكدون على أن أولى بوادر التأسيس لانتقال الدول العربية من دول تقليدية يسودها التسلط والاستبداد إلى دول مدنية حداثية تؤمن بالديموقراطية والتداول على السلطة والحريات وحقوق الإنسان ، وإن لم يتحقق أي شيء من ذلك نهائيا ، وبالتالي تم إجهاض كل تلك المحاولات في مهدها ، كانت مع بداية القرن الثامن عشر ، هذه البوادر أو هذه المحاولات التي أصبحت أكثر تطورا وتبلورا وأخذت منحى تصاعديا وأكثر فاعلية ونضجا مع فكر العديد من المثقفين العرب الذين يتم اعتبارهم بمثابة آباء الفكر الحداثي والدولة المدنية في العالم العربي ، أمثال: “طه حسين ، شبلي شميل ، فرح أنطوان ، علي عبد الرزاق وآخرون لا يتسع المجال لذكرهم ، هذا هو الاعتقاد الي يسود لدى نخبة عريضة من المفكرين والباحثين والدارسين ، وهناك منهم من يريد أن يجعل هذا الزمن الذي ذكرناه هو نقطة فاصلة بين مرحلتين تاريخيتين في تطور المجتمعات العربية على المستوى السياسي بالخصوص ثم بعد ذلك على المستوى الاقتصادي والثقافي ، لكن في المقابل وهذا ما لا ينتبه إليه الكثير من هؤلاء الدارسين أو الباحثين ، وهو أن هذه المجتمعات قبل هذا التاريخ لم تكن أرض خلاء أومجتمعات أشباح ، بل كانت تعرف دينامية كبيرة ، وتطورات بمقياس ذلك الزمن كبيرة على العديد من الصعد ، كانت تشتغل بشكل أو بآخر على مشروع دولة معين ، وهي مجتمعات ليست جامدة ، بل هي مجتمعات متحركة وقابلة للتطور الذي كان من المفروض أن يفضي في النهاية إلى ما وصلت إليه الدول الغربية على مستوى التحديث والدولة المدنية أو شيء آخر من إبداعهم على الأقل ، لكن سيقع ما لم يكن في الحسبان ، وستعرف هذه المجتمعات تحولات تاريخية كبيرة لم تكن مستعدة لها بالشكل الكافي ولم تنعكس إيجابا على المسار الذي رسمته لنفسها و انخرطت فيه سابقا ، كما سنأتي على ذلك لاحقا في سياق هذه المقالة ، وسيسحب البساط من تحت أرجلها، وسيتم تعطيل كل الديناميات فيها التي كانت تعرفها ، مما جعلها تضل الطريق وتفقد البوصلة في الاتجاه الصحيح الذي كان من الأجدر السير فيه ، لكن كل هذا لم يمنع من القول حسب أنصار هذا الطرح أن هذه المجتمعات على اختلافها ورغم أنها لا تشكل وحدة أو كتلة موحدة ومتجانسة، الا أنها عرفت محاولات إصلاح كثيرة على مر الزمن ، ونهوض الإدارات العربية والطبقات الوسطى بها ، لم يتوقف قط ، وذلك منذ مفترق طرق القرن الخامس عشر ، بسقوط الأندلس واكتشاف أمريكا أوربِّيا ، والطرق التجارية البحرية الجديدة ، ومن تم “معركة وادي المخازن ” التي أخرجت كل من ” إسبانيا والبرتغال “من ريادة النهضة الأوربية كما يذهب إلى ذلك المفكر المغربي ” عبد الصمد بالكبير “، ثم توجه المغرب جنوبا نحو إفريقيا سبيلا للتعويض عن المتوسط شرقا وشمالا ، ونفس المحاولات شملت جميع الأقطار العربية تقريبا ، بما في ذلك خاصة حركات المقاومة البحرية وحركة الإصلاح الديني والسياسي في شبه الجزيرة العربية (الحجاز ونجد واليمن )، والنهضة الاقتصادية في الشام(لبنان خاصة) ، أضف إلى ذلك إنجازات “محمد علي ثم إسماعيل ” في مصر ، و“سيدي محمد بن عبد الله ، والمولى سليمان ، وعبدالرحمان ..” في المغرب بلوغا إلى “الحسن الأول“، وبالموازاة مع ذلك جميعه ، فلقد واكبه حركة إصلاح للتعليم والإدارة والجيش ، بل وللممارسات الدينية والاجتماعية نفسها ، وجميع ذلك لم يتوقف ، الا بدخول الاستعمار ، واحتلال الأرض واغتصاب السيادة ، ومن تم الدخول في التبعية والتحديث على النمط الاستعماري ، بديلا عن الحداثة الذاتية أو المستقلة ، والمستمرة للأسف الشديد إلى يومنا هذا . ولقد أكدت دراسة في جامعة أمريكية من قبل ثلاثين باحثا في مختلف اختصاصات العلوم الإنسانية استغرقت ربع قرن ، أن منتوج التحديث الاستعماري كان في المجمل سلبيا مقارنة بالحداثة الذاتية ، وذلك في نقطة مركزية هي التبعية ، فكل ما أنجزه الاستعمار التقليدي من منجزات التحديث لمستعمراته العربية ، انتهى إلى ترسيخ الاستتباع للمراكز الرأسمالية الغربية وتعقيد برنامج استكمال الاستقلال وتحقيق السيادة الوطنية والوحدة القومية عن طريق التنمية المستقلة ، وزرع بذور الانشقاقات والانفصال وتأجيج النزاعات والصراعات ، وتوريث حدود مصطنعة بين الأقطار المغاربية والعربية ، وقس على ذلك من المشاكل التي لا زالت تؤدي الشعوب العربية ثمنها باهظا إلى حدود اليوم ، والأخطر من كل ذلك هو استحالة التقليد الاجتماعي والثقافي والديني كفضيلة وضرورة إلى التقليدانية كإيديولوجية محافظة وأحيانا رجعية فرضها التدخل العنيف والمخاتل للاستعمار ، وما اقتضاه من رد فعل مقاوم وحمائي قبلي جهوي ووطني من قبل الإدارة والمجتمع ، الاستقلال الوطني يسمح بجدل التقليد والتحديث ، في حين أن التحديث الاستعماري يمسخ التقليد إلى تقليدانية وهذا ما يفسر كون المجتمع المغربي مثلا قبل الغزو الاستعماري كان شديد الانفتاح عموما على الحداثة الغربية وإصلاحاتها ، وحالما دخلت الحداثة الغربية على الدبابة غازية بالعنف والسلاح ارتد المجتمع وإدارة دولته نحو المحافظة والتقليد والتقوقع على الذات ، والتي لم تنطلق عملية التحرير منها ، الا مع انطلاق الحركة السلفية ثم الحركات الوطنية ثم اليسارية وعملية التنوير مستمرة إلى الآن لكن دون أن تستطيع تخليص المجتمع برمته من تبعية وتبعات الاستعمار الذي وكأنه عمدا غرس بذور الحداثة في أرض جرداء قاحلة لا يمكن أن تنبت حداثة حقيقية يمكن أن يتأسس عليه المجتمع المغربي شأنه في ذلك شأن العديد من المجتمعات العربية التي عاشت نفس تجربته ، فلا هم استمروا في مشروع بناء دولة حديثة بمقوماتهم الذاتية التي قوضها المستعمر ووجه لها ضربة قاصمة يصعب النهوض من بعدها ، ولا استطاع هذا الاستعمار الغاشم نفسه بناء مجتمعات حديثة تورث حداثته وتسير على نهج الدول المستعمرة ، وبالتالي تجد المجتمعات العربية في مفترق طرق يجعل تحديد الاتجاه الذي يجب أن تأخذه رغم العديد من المحاولات التي قامت بها مع بداية القرن العشرين وفي ظل الاستعمار نفسه صعبا للغاية. ، وكل هذا انعكس سلبا على تطور هذه المجتمعات التي وجدت في ظل هذا التيه صعوبة في الإقلاع والنهوض ، التي جعلها تبدو وكأنها طائر مهيض الجناح لا يقوى على التحرك أو الطيران.
![]()