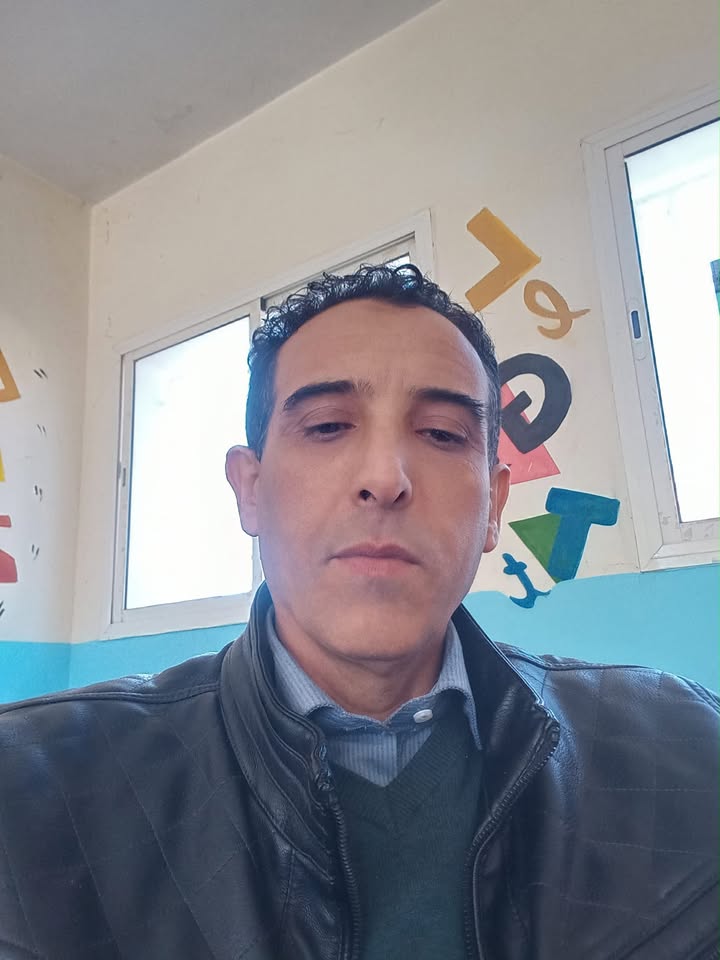من بين الشعارات الكبيرة التي رفعتها الدولة المغربية في السنوات الأخيرة شعار “المجتمع الديموقراطي الحداثي ” إلى درجة أصبح لازمة يرددها أغلب المسؤولين المغاربة من كل الأصناف بمناسبة أو بدونها لكن في الوقت نفسه نلمس نوعا من التحفظ عليه في خطابات بعض الأطراف الأخرى ، الشيء الذي يطرح معه سؤال الإجماع حول هذا الشعار ، خاصة في شقه الثاني المتعلق بالحداثة ، وإن كنت أتصور أن الإشكال لا يكمن في الحداثة كغاية في حد ذاتها ينشدها الجميع ولو بأشكال مختلفة ، لأن الحداثة أحببنا أو أبينا صارت هي المدخل الحقيقي والجوهري لمسايرة هذه السرعة المكوكية والجنونية التي يسير بها العالم اليوم ، والانخراط فيها هو السبيل الوحيد لضمان مكانة في هذا العالم ، عدا ذلك يعني البقاء خارج التاريخ وبعد عن الركب ، إذن الإشكال ليس في الحداثة في ذاتها كما أوضحنا ، وإنما الإشكال في طبيعتها ومواصفاتها وحيثياتها التي يمكن أن تنسجم والبيئة المغربية التي تتسم بالتعدد الفكري والغنى الثقافي وهيمنة التقليدانية والمحافظة بشكل كبير ، هذا فضلا على أن مسألة الحداثة في المغرب لازالت محط نقاش وجدال واختلاف فكري وسياسي ، بين مختلف الأطياف الفكرية والسياسية فيه ، ولم يتم الحسم بشكل نهائي في هذا النقاش إلى حدود اليوم ، رغم أن تمظهرات هذه الحداثة تخترق المجتمع في العمق ، وتجد أثرها في كل مكان ، وفي كل زاوية ، أما الشق المتعلق بالديموقراطية فمن النادرجدا أن تجد خطابا معاكسا لها أو يناصبها العداء ، فالذين لازالوا مختلفين حول مقومات الحداثة في المغرب وسبل تنزيلها فهم متفقون على الأقل رغم هذه المفارقة العجيبة ، أن السبيل الوحيد الذي يمكن إخراج البلاد من هذه الأزمة الخانقة التي تعيشها هو سلك المنهج الديموقراطي في سياستها ، فالديموقراطية هي الآلية الوحيدة إلى حدود الساعة رغم بعض العيوب التي تكتنفها التي تضمن للمواطن كرامته وحقوقه ووطنيته وحرية الاختيار ، دون خوف أو وجل ، كما يؤكد ذلك المفكر الفرنسي “الان تورين “في كتابه ” ماهي الديموقراطية “حيث يقول :”إنها نضال تخوضه ذوات فاعلة في ثقافتها بحريتها ضد منطق الهيمنة ” .وفي الواقع يبدو من المبكر جدا أن نتجدث عن الديموقراطية في المغرب في ظل هذا التعريف الذي سقناه ، فلا زالت لم تختمر بعد بالشكل الكافي في البنية الثقافية المغربية ولا زالت لم تنضج أيضا بنفس المقدار في ذهنية ووعي المواطن المغربي السريع التأثر بالإغراءات والميولات القبلية وضعف ثقافة الاختيار التي غالبا ما تتبع العواطف والأهواء ، وما إلى ذلك ، ليس هذا وحسب بل حتى هؤلاء الذين يؤمنون بها سواء من الطبقة المثقفة أو السياسية ، تجدهم يقفزون عليها في مناسبات عديدة ولا يبدون الاحترام اللازم لها ، ويعملون على تقويض دعائمها تحت مبررات ومسوغات مختلفة ، الشيء الذي يفسر أن ليس كل من يؤمن بالديموقراطية سيكون داعما لها بالضرورة ويضحي من أجلها مهما كلفه ذلك من ثمن ، فالسياسي حينما يفوز في أي استحقاق انتخابي يشكر و يمجد الديموقراطية التي أوصلته إلى مركز القرار، ويكيل لها المديح ، وإذا فشل أو تعثر ، فأول ما يتهم هي هذه الديموقراطية غير العادلة وغير المنصفة في نظره ، فبهذه الازدواجية في القناعات ، من الصعب أن نتحدث معها ليس عن الديموقراطية وحسب ، وإنما أيضا حتى عن الإنسان الديموقراطي ، فلا ديموقراطية بدون ديموقراطيين ، ولا ديموقراطيين بدون النهل من الفكر الديموقراطي المستلهم هو الآخر من الفكر الحداثي ، وبالعودة إلى الشعار الذي نحن بصدد الحديث عنه ، والذي يبدو ظاهريا وكأنه سهل المنال ، لكن يبدو في العمق أنه ليس كذلك ، ليبقى السؤال الوجيه التالي يتردد في الأفق ، هل تستوعب الدولة جيدا معنى هذا الشعار ودلالاته ؟ وهل تعي المجهودات الكبيرة التي يجب أن تبذلها والموارد التي عليها رصدها وشحذها والوسائل والآليات التي من المفروض أن تجعلها رهن إشارته ؟ وفي النهاية ، هل الدولة جادة في رفع هذا الشعارحقيقة ،ولها استراتيجية واضحة المعالم لتنفيذه وترجمته على أرض الواقع ، أم أنه لا يعدو أن يكون شعارا للاستهلاك وشغل الأذهان والعقول لحين من الدهر بأحلام قد تتحقق أو لا تتحقق ؟
وإذا كانت الفطرة السليمة والطبيعة السوية تقتضي من المرء اللا يبخس حق أي دولة في رفع الشعار الذي تريده ، أو الذي تريد أن تجعله عنوانا لمرحلة من مراحل تاريخها ، فإنما ما لا يجب أن تغفله هذه الدولة أو أن تتغاضى عنه هو مدى تمكنها من تحقيق هذا الشعار وبلورته على أرض الواقع ، أي أن تسائل نفسها ، هل لديها القدرات والمقومات القمينة لجعل هذا الشعار قابل للتحقق ، بمعنى أن يتحول من مجرد فكرة على المستوى النظري ، إلى معطى واقعي متحقق ، خاصة إذا علمنا أن شعارات من هذا الحجم والضخامة لا تكفي النقاشات والخطابات والندوات في الصالونات الباردة لتحقيقها ، وإنما الأمر أعقد وأعمق غورا من ذلك ، حيث لا بد من توافر العديد من الشروط ، وتضافر الجهود وتكاثفها ، يتقاطع فيها المادي بالمعنوي ، والذاتي بالموضوعي ، أي ما قد يشبه ثورة وانقلابا على مجموعة من المسلمات والمفاهيم والقيم والسلوكات التي كانت تمارس في المجتمع ، والتي قد لا تنسجم مع قيم ومبادئ الديموقراطية والحداثة المأمولتين ، فالأمر يستدعي في المقام الأول إحداث تغييرات عميقة وجوهرية على البنيات الثقافية والاجتماعية والسياسية للمجتمع ، التي تعكس أسلوب حياة ونمط تسييري ونظام تدبيري غارق في التقليدانية والتخلف ، والذي يقلب صفحات التاريخ لا مندوحة من أن تستوقفه تجارب إنسانية ، في هذا المجال ، وحجم التضحيات التي قدمتها قربانا من أجل بلوغ الشعارات التي ترسمها ، وقطف ثمارها ، ومنها من تقود العالم في الوقت الحالي ، سواء في أوربا أو آسيا أو حتى في أمريكا الجنوبية ، هناك دولا مثلنا انطلقت من نقطة الصفر والآن نراها تحقق أرقاما فلكية في ناتجها الإجمالي والدخل الفردي ومستويات جد متقدمة على مستوى سلم التنمية البشرية ، يصعب حقيقة أن نعقد مقارنة بسيطة بيننا وبينهم ، فلماذا تقدمت تلك الدول وبقي المغرب في مراتب متأخرة على سلم التنمية ؟ هل المغرب لا يتوفر على كل الإمكانات الحقيقية التي تجعله يضاهي أو يتجاوز تلك الدول ؟ أين يكمن الخلل بالضبط ؟ هذا هو السؤال الحقيقي الذي يجب أن يطرح ، ولا مناص من الإجابة عنه .
ومادام المغرب متشبت بالمشروع الديمقراطي الحداثي ، ويعقد عليه آمال عريضة للنهوض والتقدم ، باعتباره مشروعا شموليا ومتكاملا ، فإن الأمر يقتضي في البداية تحديد وتسطير عناوينه الكبرى ومداخله الرئيسية واستراتيجية تنفيذه وتفعيله ، وثانيا التأهيل الحقيقي للذات الفاعلة والحاملة له ، ولا مرية أن ذلك لن يحصل الا بالعودة إلى نقطة الأس التي يمكن أن نطلق عليها “المجال الرئيسي للاشتغال” وهي مؤسسات التنشئة ، وفي مقدمتها الأسرة والمدرسة ، إن تأهيل وتعليم الفرد ينبغي أن يكون كما يؤكد “الان تورين “في كتابه “نقد الحداثة “:”بابا يحرره من الرؤية الضيقة واللاعقلية التي تفرضها عليه أسرته وانفعالاته الخاصة ، ويفتح أمامه مجالا للمعرفة العقلية والإشراك في مجتمع ينظم نشاط العقل ، وينبغي للمدرسة أن تكون مكانا للقطيعة مع وسط النشأة والانفتاح على التقدم بواسطة المعرفة والمشاركة في مجتمع قائم على مبادئ عقلية.” والسؤال هو هل تقوم المدرسة المغربية بهذا الدور ؟ وهل تستجيب لكل هذه الطموحات والغايات ؟ الجواب طبعا ، لا ،وهذا ما يجعل مسؤولية الدولة مضاعفة في الانخراط الجاد والموضوعي في إطلاق أوراش إصلاح حقيقية للسياسة التعليمية التي تنهجها والتي لم تأت بما كان منتظرا منها إلى حدود الساعة ، وذلك بإحداث تغييرات جذرية وعميقة في فلسفة التربية وغاياتها ، حتى تتمكن من الإجابة على السؤال المحوري التالي : أي إنسان نريد ، هل إنسان المحافظة والتقليد والثبات ، أم إنسان التقنية والحداثة والعلم ؟ ومن هذا المنطلق تبدو مسألة وضع بورتريه واضح لنموذج الإنسان الذي نتوخاه في مجتمع يتلمس طريقه نحو الديموقراطية والحداثة ، مسألة مركزية وعلى قدر كبير من الأهمية ، ومادام الطموح بدون شك هو والوصول إلى إنسان التقنية والحداثة، لأنه هو الذي ينسجم مع طبيعة الشعار الذي ترفعه الدولة ، فإنه من الصعوبة بمكان أن يتحقق ذلك بهذه الأدوات الفكرية والعلمية التي نتوفر عليها ونمتلكها ، الأمر الذي يقتضي معه الاهتمام والتفكير أكثر من أي وقت مضى في آليات وجسور جديدة تمكن المواطنين والشباب بالخصوص من شروط وظروف وفضاءات يستطيعون فيها الوعي بقدراتهم الذاتية وجدارتها في الفعل والتفكير العقلاني الحر والمتحرر من الأثقال والأصفاد التي تكبله ، كل هذا في مناخ عام ديموقراطي يؤمن بالنقاش الحر والمفتوح ، ويحترم الحق في الاختلاف ، ومن هنا يبدو بجلاء أن العبور إلى المشروع الحداثي الديموقراطي يحتاج من دون شك ، في المقام الأول إلى مواطن حر وفاعل ومستوعب جيد لقيم التسامح ونابذ للعنف والتطرف ، وممتلك لناصية التفكير والفكر المنفتح والحوار ، ولهذا يجوزالقول أن العلاقة التي تربط الانسان بالحداثة ليست علاقة اعتباطية أو عفوية بل الحداثة تعتبر الانسان هو مركز العالم وعليه يدور المدار ، وتعظمه إلى درجة تصير معه كل إنتاجاته وكأنها هي الحقيقة التي لا يمكن أن تضاهيها حقيقة ، فمن المستحيل أن نتصور مجتمعا حداثيا ديموقراطيا دون الاشتغال على هذه المعطيات والمحددات الأساسية ، ودون أفق اشتغال كهذا . وحينما نخلص إلى إنتاج أوصناعة إنسان بتلك المواصفات والخصائص ، حينئذ يجدر بنا الحديث عن الحداثة والديموقراطية ، كل هذه المجهودات التي يجب أن تبذل في سبيل تحقيق هذا المشروع المنشود خاصة على مستوى التعليمي ، رغم فاعليتها وجدواها ، الا أنها لا تمثل في الحقيقة الا نصف المسافة على طريق هذا الهدف ، أما ما يتصل بالنصف الثاني من المسافة والذي يبدو هو أيضا شاقا ، فيجب أن يخصص للمعالجة الكبيرة والشاملة لجملة من الإشكاليات الأخرى والحسم فيها نهائيا وبدون تردد ، ومنها بالخصوص إعادة ترتيب العلاقة مع التراث والماضي ، وأن نجعل العقول تتجه نحو المستقبل ، فالتقديس النرجسي للماضي على علاته قد يحمل بين ثناياه بعض مثبطات لوثائر التقدم وبعض معيقات بناء الحاضر والمستقبل ، وكذا تحقيق بعض المشاريع التي يتم الاشتغال عليها في الوقت الراهن ، هذا بالإضافة إلى مجموعة من العمليات التي تعتبر أيضا من دعامات هذا المشروع والتي يجب الانتباه إليها وهي تستهدف بعض القيم التي يجب على الفرد تمثلها تمثلا سليما ، وتجاوز بعضها ونبذها مثل العنف الإيديولوجي والتكفير وتعطيل ملكة العقل ، وكذلك العمل على اجتراح مفهوم جديد للهوية ، على اعتبار أنها ليست كينونة ناجزة اكتملت في لحظة سابقة ، بل هي سيرورة وعزل واستدماج مستمرة ، وفي النهاية لا بد من العودة إلى التاريخ لدراسة وتأمل تجارب المجتمعات التي حسمت في مثل هكذا خيارات ومواقف ،لاستخلاص الدروس والعبر ، ولما لا الاقتداء بها ، ومنه سنجد من دون أدنى مواربة أن الحداثة ماهي الا نتاج حوار دائم ومثمر بين العقل والواقع والمجتمع .
من نافلة القول أن شعار المجتمع الحداثي الديموقراطي من حيث الشكل شعار مغري وجذاب وساحر للأعين إلى حد كبير ، لكن في الوقت ذاته لا يجب أن ينسينا ذلك وضع الأصبع على الداء بكل جرأة وشجاعة وإرادة والبحث عن العلاج الشافي له دون لف أو دوران ، ورغم كل هذا الكلام الذي قيل ويقال حول هذا الشعار ، ورغم كل هذه الإشارات والمؤشرات الإيجابية التي توحي أن قطار الحداثة والديموقراطية قد انطلق ، الا أن الواقع لا يرتفع ، مما يعني أننا لا زلنا لم نبرح نقطة البداية بعد ،ولازالت الأمور يسودها نوع من التوتر والتردد ، وهذا ما يعطي الانطباع أن هذا الشعار لا يمكن أن يخرج من شرنقة الشعارات الاستهلاكية ، والواقع ينذر بأنه سيبقى كذلك ما لم يتم الانكباب بشكل ملموس ومستمر بتسليح الحامل المنتظر لهذا المشروع علميا ومعرفيا ، وذلك بإعادة الاعتبار للفلسفة على أساس كونها أحد المعدات التي تساعد على النقد والخلخلة والتفكيك والمراقبة والتقييم والبناء ، وهذا طبعا في جو تسود فيه إرادة سياسية حقيقية تتفهم الواقع وتقرأ المستقبل ومتطلباته .
![]()