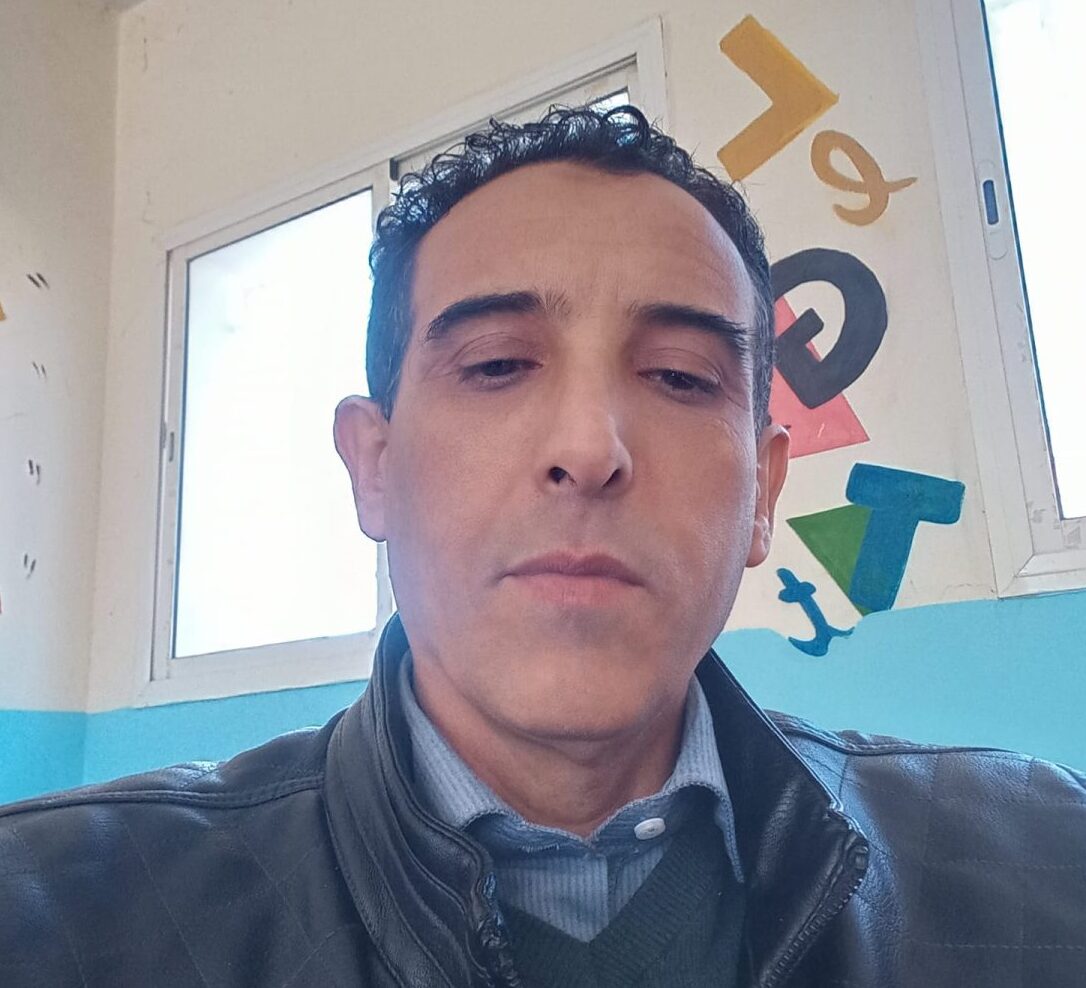لايمكن تصور منظومة تربوية فعالة وناجعة إلا إذا استطاعت أن تضع نصب أعينها أمرين اثنين مهمين وهما أولا: تحديد شكل العلاقة بين التلميذ والمعرفة بمختلف أشكالها وتلاوينها في إطار سؤال فلسفي مركزي وهو كيف تبني الذات علاقتها بالمعرفة ؟ ومنه ماهي العلاقة القائمة بين التلميذ وماضيه وتاريخه من جهة ،وبين المضامين المعرفية لمادة معينة من رياضيات أو أدب أو تاريخ..؟ إنه لا يمكن فصل ما نتعلمه عن كيفية تعلمه.وماهو مهم هو ما يربط بين مضمون التعلم وكيفية تعلمه ،فهذا ما يسمى بالعلاقة بالمعرفة ،فما هي العلاقة الموجودة بين تلميذ معين ومادة دراسية معينة ؟ هل هي علاقة استهلاك أم علاقة إبداع أم علاقة استخدام اجتماعي أم انتقاء…؟والأمر الثاني هو التطور العلمي، لا بد لهذه المنظومة أن تستحضر هذا الهاجس وبقوة في صياغتها لاستراتيجيات التدريس والبرامج التي تنسجم ونمط التعلم والأهداف التي تنشدها من ورائه ،وأن تتماهى في ذلك مع متطلبات العصر الذي يمكن اعتباره عصر العلم بامتياز، ويقتضي الأمر في هذا الصدد اعتبار أن التطور العلمي أساسا ليعرف الفرد أن المعرفة تبنى وأنها نتاج لتاريخ ومغامرة إنسانية ،كما يتطلب ذلك تعلمه كيفية مواجهة اللا يقين ومعرفة المعارف من خلال إنتاجها، وهكذا يكمن مجهود العلم في الغوص فيما وراء المظاهر ،عبر آليات بيداغوجية تكون هذه المنظومة قد اضطلعت بها وحددتها تحديدا دقيقا .وما دام أن أمر بلورة وتفعيل كل هذه الأفكار والنظريات على أرض الواقع فهي من صلب اختصاص المكونات الأربعة لهذه المنظومة بمختلف الصفات والدرجات والمستويات وهي: الجهات الرسمية الوصية والمدرسة والمدرس و التلميذ ،فإن لا بد من أن يعرف كل عنصر من هذه العناصر ما يجب عليه فعله في هذا السياق ،وأن يمتلك ذلك الفهم الجيد لجوهر المطلوب ،وأي سوء فهم لعنصر من هذه العناصر أو عدم السير بإيقاع واحد وتناغم تام لا يمكن أن تفضي العملية إلى أي نتيجة ملموسة في النهاية ،ولا شك أن فشل كل الإصلاحات التي باشرها المغرب مثلا في المجال التعليمي والتربوي وتغيير البيداغوجيات على مر سنوات طوال كان سببها هو هذا الذي ذكرناه ،حيث كان كل مكون من تلك المكونات يشتغل بمعزل عن الآخر وكأنهم في جزر متفرقة ،في غياب شبه تام لكل أشكال التواصل بينها ،الشيء الذي يفرض هاهنا احترام الصلاحيات وعودة التناغم والانسجام فيما بينها ،فلكل مكون صلاحياته التي يجب أن يمارسها عن دراية وعن علم حتى يؤديها على أكمل وجه..
لعل من نقط الضعف التي يمكن أن تنوء بها أي منظومة تربوية هي حينما يتوقف الباحثون في التربية عند مقاربتهم لعلاقة الذات بالمعرفة أو بناء تصور جديد منسجم مع روح التطور العلمي بالمعاينة السوسيولوجية فقط دون الاشتغال على الطرائق البيداغوجية والتصورات الديداكتيكية التي تمكن من جعل هذه العلاقة بحثا عن الحقيقة ،إن ما يجب أن تعلمه المدرسة للمتعلم هو بناء علاقة بالحقيقة ،وهنا تظهر مهمة البيداغوجي الذي يستوجب عليه وضع ترتيبات تسمح للتلميذ بالانخراط في عملية البحث عن الحقيقة ،وذلك من خلال مقاربة صارمة ترمي إلى الإجابة على أسئلة يطورها هو ذاته ،وهكذا يجب أن يكون هدف المدرسة هو تمكين كل واحد من القدرة على الاشتغال بمعارف كونية من أجل الإجابة على أسئلة خاصة،دون أن يعني ذلك تدخل في تحديد المعارف المراد تقديمها ومعرفتها لأن هذا الأمر من اختصاص المجال السياسي ،بحيث هو المنوط به تحديد نوعية الفرد المراد صناعته كمواطن فعال،والمشروع المجتمعي المرغوب في بنائه،لكن في بعض الأحيان تغيب هذه النظرة في بعض المنظومات التربوية ،وفي النهاية تجد بعضها بعيدة كل البعد عن التصور القبلي لهذا المشروع ،والأسباب في ذلك كثيرة ومتعددة،لكن يبقى أهمها هو عدم وضع برامج دراسية تمتاز بالتماسك الاجتماعي والسياسي،وهذا ما يجب أن يكون محط نقاش داخل المجتمع، وليس توافقا بين جماعات الضغط والإدارة، إنه لرهان ديموقراطي كبير أن يناقش المجتمع التوجهات الكبرى للبرامج الدراسية كما يقول“فيليب ميريو“، أما دور المدرس هنا فيمكن في الربط بين المعارف الكونية والأوضاع الخاصة لتلاميذه واجتراح آليات ووسائل لإشراكهم في مغامرة المعرفة والنفاذ إلى أغوارها بالبحث والاكتشاف،وهي في الحقيقة ليست مغامرة تخص التلميذ وحسب ،بل هي مغامرة للمدرس نفسه ،حيث يجب عليه تنويع طرائقه واختراع وسائل جديدة لتحفيز تلاميذه ويعيد النظر فيها وفي آرائه إذا فشل،أو لم يصل إلى تحقيق الأهداف المتوخاة،إن صياغة أو بلورة استراتيجية تربوية قادرة على تحقيق مشروع مجتمعي يرقى بالمجتمع إلى مصاف الدول المتقدمة ينطلق من ضرورة القيام باصلاحات تنسجم وضرورات العصر ،وذلك بإبداع أو إنتاج برامج تساير التاريخ المعاصر ومتطلباته ،ووضعها أو صياغتها بطريقة سليمة ،وتحديد تأسيسا على ذلك طبيعة العلاقة التي يجب أن تربط المدرسة بالمعرفة ،وأن تكون هذه المضامين المعرفية ذات بنية وتعاقب ومعنى وفاعلية،وتشكل أداة للتفكير وتطوير المفاهيم،كل ذلك عبر مهارات وطرائق وأساليب تفتح شهية المتعلم لالتهام هذه المعرفة وتمثلها ،وتفتح له أيضا آفاقا لبدائل مستقبلية أكثر إشراقا .
إن أي منظومة تربوية إذا لم تستطع تدريس للمتعلمين ما يوحدهم ويحررهم ،وهذا ما يسمح للناس أن يجدوا أنفسهم متشابهين رغم وجود الاختلاف بينهم ،وتسمح للفرد بالتجرؤ على التفكير بذاته كما يقول“كانط“،الأمر الذي يمنحه امكانية التحكم في مستقبله الخاص ،دون أن يترك الآخرين فرصة التلاعب به.فإذا لم تصل إلى هذا المستوى ،فهذا دليل على أن هذه المنظومة متخلفة، وثمة عوائق و اختلالات بنيوية تحكم السيطرة عليها لا مندوحة من تجاوزها وتصحيحها.
![]()