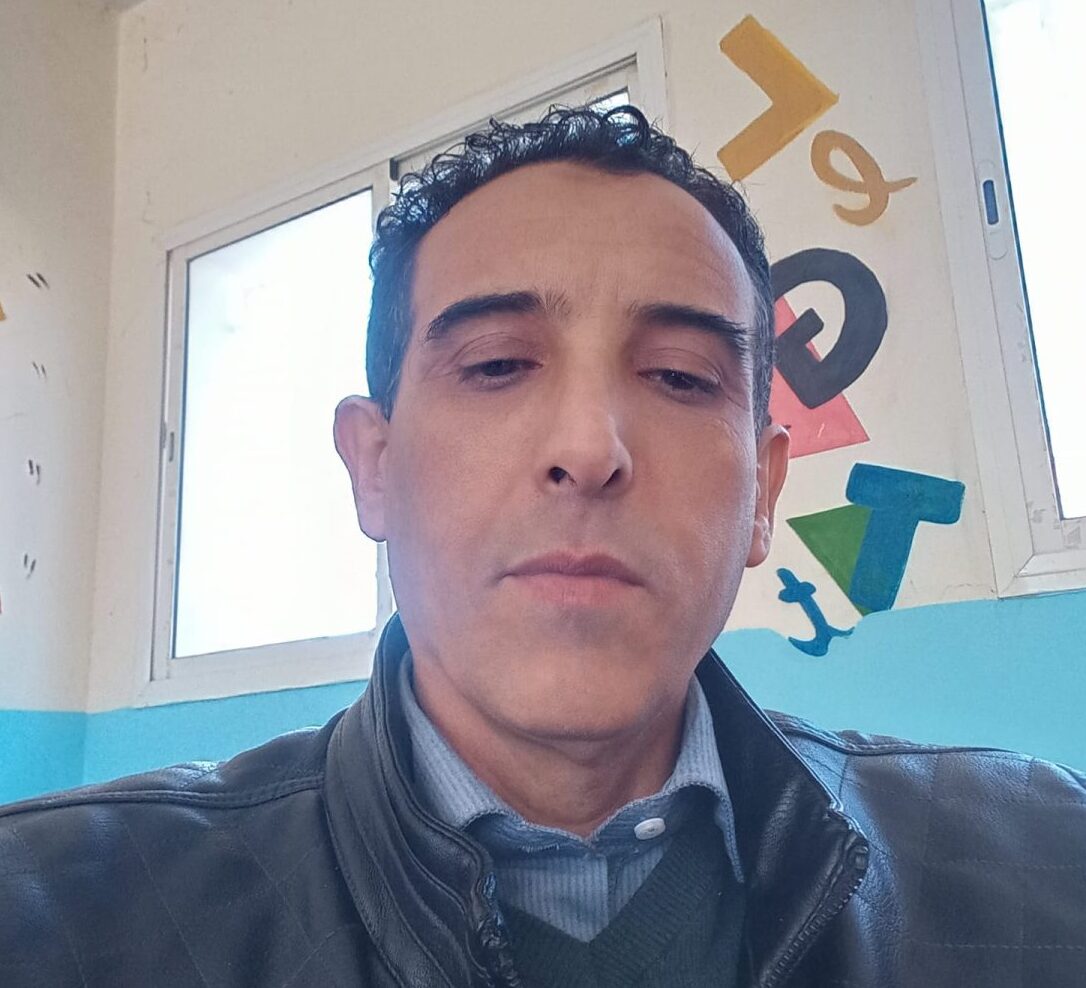لا أتصور أن هناك ظاهرة تربوية تؤرق الكثير من الدول سواء المتقدمة منها أو المتخلفة ولو بدرجات متفاوتة أكثر وأشد من “ظاهرة الكسل والتعثر الدراسي “أو ما يمكن تسميته إجمالا “بالتخلف الدراسي“،ونظرا لكون هذه الظاهرة صعبة ومعقدة ،فإنها تشقُّ على جهة واحدة دون غيرها التعاطي معها مهما كانت درجة الإمكانيات التى تتوافر عليها ،قديما كان الجميع يعتقد أن المسألة من اختصاص علماء النفس والاجتماع وحسب،لكن مع تطور الأمور بدأ يتضح جليا أنها تتعداهما إلى جهات وقطاعات أخرى كالفلسفة والفكر والدين والسياسة والاقتصاد ،وما إلى ذلك من المجالات التي يبدو أنه بتضافرها وتناغمها يمكن أن تتمخض عنها جملة من الخطط والاستراتيجيات ،التي من شأنها أن تحد من هذه الظاهرة ومن تبعاتها الكثيرة ،كالهدر أو التسرب المدرسيين ،الشيء الذي ينعكس سلبا على مردودية المتعلم ومستقبله بشكل عام ،خاصة وأن العديد من الدول تنفق أموالا باهظة على التلاميذ المتخلفين دراسيا ،ويظهر أن العديد منها تنتمي إلى خانة الدول المتخلفة أو النامية ،بحكم أنها المتضررة بشكل كبير من هذه الظاهرة ،وكما لا يخفى على الجميع اليوم ،فإنه إذا كانت الحضارة الإنسانية الراهنة قد أكدت أهمية الطاقة البشرية ودورها في تنمية المجتمعات وتقدمها ،فإنه في ذات الآن تعتبر ظاهرة “التخلف الدراسي” أكبر تحدٍّ أمام هذه التنمية وتعتبر أيضا بحق من أكبر الوسائل المستنزفة لطاقة المجتمع الإنسانية والاقتصادية ،والتي تتمثل في عدد السنوات التي يضيعها التلميذ في التكرار ،وفي الأموال التي تنفقها الأسرة والدولة نتيجة هذه الظاهرة ،ومن هذا المنطلق يبدو من الواضح أن أي إقلاع تنموي حقيقي أو أي تقدم ملموس منشود لا يمكن أن يتأتى لأي مجتمع إلا بالقضاء نهائيا على هذه الظاهرة ،التي تحتاج في حقيقة الأمر إلى معالجة شمولية من جميع الجوانب ،ونحن في هذه الورقة إذ نثير الانتباه إلى هذه الظاهرة فلأنها من بين الظواهر الحساسة التي تعيق التنمية في بلدنا بشكل خاص ،والتي لا زالت تحتاج إلى المزيد من الدراسة والاهتمام ،وثانيا للاِسهام في تسليط المزيد من الأضواء عليها انطلاقا من مقاربات نظرية علمية عميقة ،وهي نتاج دراسات نفسية واجتماعية لذوي الاختصاص ،تحمل بين طياتها أهم المداخل الحقيقية لرصد هذه الظاهرة وتجاوزها أو على الأقل الحد من وطأتها بشكل تدريجي ،ولا مراء أن الاستفادة منها تعطينا تصورات واضحة وليست مجردة حولها.
ليس من السهل أن يحيط كل مهتم أو باحث في التربية بكل الدراسات والمقاربات النظرية أو الميدانية التي قاربت ظاهرة التخلف الدراسي نظرا لغزارتها وكثرتها وتنوعها ،ولهذا ارتأينا في هذا السياق التركيز على أهم هذه المقاربات ،والتي يظهر أثناء الخوض فيها أنها تفي بالغرض وزيادة ،ونستهلها بدراسة “لجورج موكو” الذي يحاول وضع الأصبع على أهم أسباب “الكسل“الذي لا يختلف حسبه عن مفهوم “التخلف“،فالتلميذ الكسول هو الذي يظهر عجزا في التكيف مع متطلبات المدرسة ،ولا يظهر التفاعل المطلوب معها ،ويعزو هذا العالم ذلك إلى عوامل جسدية وعقلية وعاطفية وطبيعية ،ومن جهة أخرى إلى عوامل تربوية محضة ،فأما العوامل الجسدية فتتجلى في تعطل النمو والاضطرابات الفيزيولوجية للمراهق والانهاك الوقتي ونقص الفهم ،كما يمكن أن تنجم عن عدم الكفاية الفيزيولوجية للتلميذ كاختلال الغدة الدرقية ،وأن تنتج عن بعض النقص الحسي ،كضعف الرؤية أو السمع ،هذا إضافة إلى حالات الضعف العقلي أو البلاهة المنتشرة بين صفوف التلاميذ الكسالى ،وأما العوامل الطبيعية فيلخصها هذا العالم أولا في ضعف “الأنا“،وضعف الأنا هذا يعود إلى الخبرات الأولى للطفل وإلى نزاعه مع البيئة العائلية ،وإلى الشعور بعدم الأمن ،وفي بعض الأحيان إلى إجحاف المعلمين أو عدم تفهمهم لنفسية المتعلم ،أما بخصوص العوامل التربوية فيمكن حصرها في المناهج المثقلة والتعليم المجرد ،وضعف الخبرة التربوية لدى العديد من المدرسين ،إضافة إلى التغيبات الكثيرة للمتعلمين ،ناهيك عن انتقالهم بين مدرسة وأخرى ،وما يترتب عن ذلك من اختلال في المستوى الدراسي والعلاقات الانفعالية والاجتماعية ،أما بخصوص دراسة العالم “بيرنار شارلو” فهو يتحدث عن هذه الظاهرة من زوايا متعددة ،نفسيا وتربويا وسوسيولوجيا، وخرج بالخلاصات التالية:إن الرسوب المدرسي ليس إلا نتاج لظاهرة التفرقة والعنصرية التي يعيشها بعض التلاميذ ،ولا أعتقد _يقول شالو_أن التلميذ الذي سيخسر دراسته لن يخسر حياته ،والعكس صحيح ،ويضيف أن الرسوب يخدم المجتمع النفعي ،إذ بواسطته يتزود باليد العاملة ،ويركز “شالو” على أن الرسوب المدرسي يضرب بقوة أطفال الأسر المتحدرة من أوساط ذات الدخل المحدود ،فهؤلاء الأطفال يرسبون بكثرة ،ليس لعدم الاستعدا الطبيعي أو البيئي ،ولكن لأن المدرسة لا تستجيب لرغباتهم وحاجياتهم ،وبالتالي فإن الرسوب أو النجاح هو نتيجة لمواءمة أو عدم مواءمة المدرسة للطفل ،ونختم في هذا السياق بدراسة ” أندري لوجال“الذي يربط نسبة كبيرة من التخلف الدراسي بعدم تكيف شخصية المتعلم مع متطلبات المدرسة ،هذا التكيف الذي يمكن أن يحدث في نظره بالتقاء المعلم والمتعلم في منتصف الطريق ،ودور المدرسة هو تسهيل هذه العملية ،أما بخصوص العامل السوسيواقتصادي ،فمهما كانت درجة أهميته فإنه يبقى عاملا خارجيا ومسألة التحكم في بعض تأثيراته وتداعياته قد تكون متاحة ،فهذا “العالِم” يريد انطلاقا من دراسته إعطاء الأهمية القصوى للأساليب البنيوية والوظيفية المتحكمة في هذه الظاهرة ،ويقصد بالأساليب البنيوية النسق المدرسي المتبع الذي يطغى عليه الطابع الانتقائي في معظم الحالات ،خاصة عند الدول النامية ،هذا فضلا عن البرامج المدرسية التي تعتمد على الذاتية وعلى التخويف والترهيب ما دامت ستكون مادة امتحان ،أما الوظيفية فيقصد بها “لوجال“العوامل السيكوسوسيولوجية وتتجسد في شعور التلاميذ بالتبعية وقلقهم أمام الامتحانات ،هذا علاوة على عدم اهتمام جل المدارس وهذا هو الأهم ،بالجانب العاطفي ،وخاصة في المرحلة الابتدائية ،وفي النهاية يربط “لوجال“هذه الظاهرة في كثير من أبعادها بخصائص الطباع الأربعة التي يحددها في الطبع الجموح والغضبي والعاطفي والعصبي.
وتجدر الإشارة أن هناك الكثير من المهتمين بالحقل التربوي الذين يرجعون هذه الظاهرة في شق كبير منها إلى عامل الذكاء ،ذلك أن التلاميذ الذين لا يتمتعون بقدر كاف من الذكاء هم الذين يتعرضون للتخلف الدراسي ،إلا أن “لوجال” لا ينساق وراء هذا الطرح ولا يتفق معه ،حيث يعتبر أن الذكاء بمفهومه الحالي متأثر بعوامل شخصية مدرسية وسوسيوثقافية ،وهذاما تؤكده العديد من الدراسات الأخرى البيولوجية بالخصوص ،والتي يمكن أن نذكر منها دراسة “لوسيان سيف” و“”ميشال راموز “.
بعد هذا الرصد المختصر لأهم أسباب ظاهرة“التخلف الدراسي ” نتطرق الآن إلى بعض الوصفات العلاجية التي حاول العديد من العلماء والباحثين التوصل إليها بناءا على معطيات علمية دقيقة ،ونتوقف بشكل خاص عند“روبرت غالتون “في بحثه” دور المدرسة ” الذي يذهب الى أنه إذا أردنا أن تكون المدرسة منتجة يجب ان نحدث مدرسة مبنية على الطفل وحاجاته وعلى وسائل الطفل الخاصة مع مراعاة حاجات عالم الغد ،حسب امكانيات التنبؤ بها،كما نجد “فليب مبيرو” يميل من جهته في بحثه ” الفشل الدراسي تكوين معقد ” إلى أن علاج الفشل الدراسي يتوقف على العوامل الآتية. أولا:إلا نقتصر على ما يقع في المدرسة فقط،بل يجب إثارة اهتمام الآباء حول دور الغيرة والتقمص والتشبيه وحول التفتح الثقافي للطفل في المجالات التي يرغب فيها ،ثانيا: إن معرفة الإعاقة الموجودة في العلاقة بين الأبناء والآباء والمربين أمر ضروري لتجاوز الفشل الدراسي ،ثالثا: من الضروري الاهتمام بالتكوين السيكوبيداغوجي للمعلمين للتعرف على ظروف النمو للاستعدادات الموضوعية ،وكذا التعرف على شخصية الطفل ،وذلك خلال السنوات التكوينية أيضا عن طريق التكوين المستمر ،رابعا: أن يكون هناك تفكير نقدي وبيداغوجي للبرامج والطرائق التعليمية التي تعتبر مسؤولة بدرجة كبيرة عن الصعوبات المدرسية ،وإضافة إلى ذلك يمكن القول إن عملية علاج التخلف الدراسي ليس بوسعها أن تستقيم إلا بالاعتماد على الأسلوب النفسي الذي يهدف من ضمن ما يمكن أن يهدف إليه إلى محاولة تغيير الاتجاهات السلبية نحو الدراسة ،وتنمية دوافع التلميذ مع تغيير مفهوم الذات لديه ،بالاعتماد على الأسلوب التربوي والاجتماعي ،وذلك باستحضار الفروق الفردية في المدرسة ،وإسناد عملية تدريس المتخلفين دراسيا إلى مدرسين أكفاء ،هذا دون أن نغفل جو المدرسة الذي يجب أن يكون صالحا ومشبعا لاحتياجات التلاميذ ،كما يجب ان تكون الصلة وثيقة بين المدرسة والمنزل.
![]()